
الموتى لا ينتحرون رواية جديدة للكاتب سامح خضر، تناولها نادي حيفا الثقافي والمجلس الملي الأرثوذكسي الوطني حيفا، بتاريخ 9-7-2016 في قاعة كنيسة القديس ماريوحنا الأرثوذكسية في حيفا، وسط حضور منالأدباء والمثقفين والمهتمين والأصدقاء، وقد رحب المحامي فؤاد نقارة رئيس نادي حيفا الثقافي بالحضور، ثمّ تولت عرافة الأمسية الشاعرة ليليان بشارة منصور، وتحدث عن الرواية كل من د. راوية بربارة والكاتبة هيامأبو الزلف، وكانت مداخلات من الحضور لشيخنا الأديب حنا أبو حنا، والكاتبة الإعلاميّة سعاد قرمان، والمحامي حسن عبادي، ود. إلياس زيدان، وأنور سابا، وسلمى جبران، ومحاورة قصيرة أجرتها خلود فورانيسرية، ثم تحدث الكاتب سامح خضر وشكر الحضور والقائمين على تنظيم الأمسية، وفي نهاية اللقاء تمّ توقيع الرواية والتقاط الصور التذكارية!

مداخلة د. راوية بربارة: مساؤكم عابقٌ بالحياة، ليس لأنّ الموتى لا ينتحرون، بل لأنّ الأحياءَ منّا يعرفون بأنَّ الحياةَ أثمنَ مِن أن نُقايضَها بالموت، فعلى هذه الأرض نبضٌ مستمرٌّ للحنين إلى رائحةِ البيتِ والأهلِ والترابِ الذي سِرنا عليه حفاةً أوّل مرّة، وللقلوبِ التي تنبضُ فرَحًا حين رؤيتنا، فالموتى لا ينتحرون.. عنوان ملخّصٌ، كشَفَ لنا فيه سامح خضر حقيقةً نعرفها، مفادها أنّ الموتى ليس باستطاعتهم الانتحار، لأنّ الانتحارَ يعني مفارقة الحياة، والموت هو مفارقة الحياة، فكيف يمكن لفاقد الحياة أن يعطيها الحقَّ في الانتهاء؟ هذه مفارقة لا تتمّ إلّا إذا كان أحدُ المعاني مواربًا، فالموتى ليسوا أمواتَ الجسد، إنّما هم موتى الروح “ربِّ أرِني كيف تحيي الموتى”، فالموتى كلمةٌ تستعمل لمن مات حقيقة بخروج الروح من الجسد، وأبطال الرواية ماتت أرواحُهم، فما نفعُ الجسد إذا انتحر؟ هل يُقدِم الميّت على الانتحار إلّا إذا كان جسدُهُ حيًّا؟ وهذا يعني بأنّ الموتى في العنوان هم أحياء، وهذا الميّت الحيّ عبارة عن أوكسيمورون، إردافٌ خُلُفيّ كصوتِ الصمت، والنهار المعتم، والمنتحر الذي لا ينتحرُ. إذًا؛ نتوقّع أنَّ الروايةَ تقوم على التضادّ، وأصعب ما في التضادّ أن يكونَ بينَ الشيءِ وذاتِهِ، أن تكونَ ميّتًا وأنت على قيد الحياة، أن تكونَ منتحرًا وأنتَ ممّن لا يستطيعون الانتحارَ، أن تكونَ أنتَ ولا أنتَ!

العنوان ملخّصٌ، لأنّه أنبأنا أنّ شخصيّاتِ الرواية عانتْ مأساةً صعبة، أفقدتهم قيمةَ الحياة ومعناها، فما الذي منعهم مِن الانتحار؟ سؤالٌ يتركُ في العنوان فجوةً تحثّنا على متابعة القراءة، لسبر أغوارِ النصٍّ واكتشافالأسباب، وبهذا يدعونا الكاتب من العنوان، لنصبحَ قرّاء مشاركين في تتبّع الأحداث، والتفاعل معها واستيعابها أو رفضِها، فيسردُ الحاضرَ متّكئًا على الماضي بكلِّ تبعيّاته، فكيف لحاضرٍ أن يقومَ بذاته؟ أليس هو محطّةآنيّة للانتقال بين زمنيْن، أحدُهما انتهى ولا خيار لنا في تغيير أحداثه، والثاني سيبدأ غدًا وعلينا أن نمسكَ زمامَ تحكّمه فينا.

سامح خضر يتّكئ على الماضي الفلسطينيّ للفلسطينيين في مكانيْن، في فلسطين وفي بيروت، ليقولَ لزمان الوهم كفاكَ بطولاتٍ، كفاك دموعًا، كفاك “ارحمنا من هذا الحبّ القاتل”، تعال افتح أوراقًا لم يجرؤ كثيرون علىفتحها، وانثر لنا الخيبات والزلّات واللامتوقّع.. اكشف لنا حقائق نتغاضى عنها رغم وجودها، ونريد أن نجمّلَ لوحتنا الفلسطينيّة باسم القضيّة، ولكنّنا في الأدب وفي الفنّ لا نجمّل الواقعَ، بل نأتي به على قذارته وقبحِهِ، لنتحدّاه، لنبوحَ به فنزيل عبئًا راقدًا على صدورِنا، فكما قالت “حياة” لإياد في الرواية “أبوح لأنّ البوحَ يُصلحُ روحي” (الرواية ص. 47)، وسامح خضر يبوح في الرواية، لأنّ البوح يطهّر الفلسطينيين من الألم الاجتماعيّ النفسيّ السياسيّ المَعيش، ليقول هذا مجتمعٌ عاديٌّ على كِبَر قضيّتِهِ، هؤلاء أناس يخطئون بحقِّ بعضهم، وبحقِّ أنفسهم رغم فداحةِ ما حلّ بهم.

إنّ السببيّة التي تحكم العنوانَ، هي نتاج صراعاتٍ اجتماعيّة- سياسيّة كان سامح خضر جريئًا في طرحها، فالموت هو نتيجة، والانتحار هو السبب، لكنّنا في العنوان نجد اللانتحار، اللاسبب يؤدّي إلى نفس النتيجة- الموت؛فيتحوّل الموت من نتيجة إلى سبب، فلأنّهم موت، النتيجة أنّهم لا ينتحرون.. هذا التبادل للإيجاب والسلب وللتضادّ وللتناقض هو قاعدة الأساس، لأحداث الرواية التي تنتفض وتسير “على قلقٍ كأنّ الريحَ تحتها”؛ فرياح سفاح القربى تنعف “حياة” التي يغتصبها جدّها؛ ربيب المجتمع الذي يتعاملُ مع الناسِ بظاهرهم، والذي يرفع من شأن أناسٍ لو عرّاهم على حقيقتهم، لكان رجمهم حتّى الموت عقابًا رحيمًا…

ارتياح التضادّ في الرواية ليس في العنوان فحسب، إنّما في أسماء الشخصيّات، فشروق السوريّة قد غربت حياتها بعد أن أخذ البحر ابنَها، وأخذتِ المأساةُ زوجَها.. وتلك “حياة” عاشت الموتَ ستّ سنوات عجافٍ، لأنّ “حاميها حراميها”، لأنّ جدَّها “الموقّر” كبيرَ العائلةِ والقريةِ أرادها لنفسِهِ، لجنونِ عظمَتِهِ، لم يردعْهُ أنّها حفيدتُهُ، ولم يردعه يُتمُها، ولم يردعه أنّه اغتصبَ والدتَها قبلَها، فـــ”أمينة” الأمّ كانت أمينة على ثلاثةِ أيتامٍ تركهم “مشعل” يحترقون بنار الجدّ، كانت تخاف إن لم تلبِّ طلبَ حماها أن يقتلَها، أن يقتلَ أبناءَها، أن يحرمَها رؤيتهم، رغم أنّها كانت لابن عمّها، وأخذها الجدّ لابنه مشعل، فكانت بذلك سببًا في علوّ شأنِهِ، ثمّ بعد أن ترمّلتْ أصبحت سببًا في تسلّطِ عنجهيّته التي قوّاها عنده المجتمع، فهو سيّد البيت وحامي الحِمى، بينما أولاده كالأغلبيّة في عمرهِ، يعملون في إسرائيل لجلب القوت لعائلاتهم.

هنا، كما في كلّ الرواية يتجرّأ سامح على تعرية هذا الواقع الاجتماعيّ القذر، على تعريةِ هذا الواقعِ الفلسطينيِّ الذي لا يليق بمكافحٍ، محتلٍّ، مناضلٍ، فدائيٍّ يرى الهويّةَ الفلسطينيّةَ كفاحًا وبطولةً، كما كان يراها “إياد” الذي عاش مأساة تل الزعتر، والذي كانت تحلم أخته الصغيرة “وردة” برؤية فلسطين، فيأتيها الجواب من أمّها “حين يكبر إياد”، وقد ورد على لسان إياد عنها “أبقت وردةُ فلسطينَ حاضرةً فينا.. كانت الناطقة باسمها..الجرَس الصغير الذي علّقه الله في رقابنا، كي لا ننسى أين نحن وأين يجب أن نكون” (الرواية ص. 21)، وردة الجرس الصغير الذي علّقه الله في رقابنا، كي لا نصبح خرافًا ضالّة، وباستشهاد وردة في تلّ الزعتر، فقدْناالبوصلةَ، وفقدْنا الحلمَ بالعودةِ إليها، فكيف سيعود إياد إلى فلسطين، والمجزرةُ تركت والدته وأختَهُ جثّتيْن منفوختيْن، وتركته في الرابعةَ عشرةَ من عمره لا مأوى له، ولا حلم إلّا السلاحَ لينتقمَ، فينضمّ إلى المقاومين بعد أنأخذ سلاحَ مقاتلٍ قد قضى، وتتتالى عليه الخيبات، لتكونَ أصعبها حينَ حُمّلَ بالسفينة للخروج من بيروت، وهنا ذكّرني المشهد الروائيّ بمقطعٍ من قصيدة لمحمود درويش، قصيدة “يأس الليلك”: تذكرْتُ أنّي تذكّرْتُها يومَمالَ الحديدُ عليَّ ومالَ الزبدْ/ إلى أينَ يا بحرُ؟ لي إخوةٌ من نحاسٍ، ولي لغةٌ مِن جَسدْ.

وتتتالى الخيبات على إياد، فقدُهُ لأمِّهِ، فقدُهُ لأختِهِ وردة، فقدُهُ للسلاح وقد نشأت بينهما علاقة أبوّةٍ، المجزرة، الخروج من بيروت، من اغتراب الاغتراب عن الوطن الأمّ إلى ألمانيا، ليصبحَ إنسانًا مهشّمًا مهمّشًا، فها هو حين وصوله يصيح في شواره ألمانيا “أنا فلسطينيّ، أنا فلسطينيّ من بيروت”، لكنّ أحدًا لم يأبه ببالون البطولةِ المنتفخِ..أحدًا لم يعبأ بالفلسطينيّ ونضاله وحياته وموته وبقائهِ ورحيلهِ، فانفجرَ هذا البالون وتطايرَ الوهم، ليصبح إياد في عداد الموتى الذين لا ينتحرون، الموتى الذين يجمعهم القاسم المشترك “الخذلان من الدنيا” (الرواية ص. 20)، “يجمعهم الموتُ الصغيرُ المتكرّرُ الذي يُعطّلُ فكرةَ الانتحار” (الرواية ص. 66).
إنّ فضاءات البوحِ في الروايةِ تفقأ الوهمَ الفلسطينيَّ المترنّحَ على حدود الخيبات، وعلى حدود البطولات، وعلى حدود من ضحّوا بحياتهم، وأولئك الذين بقوا على قيد الحياةِ يعاينهم الموتُ، “لأنّ الألم الأكبر أن نظلَّ أحياء ونرى الحلم يتبدّد” (الرواية ص. 99)
وسامح خضر بجرأته ربّتَ على كتف مآسينا وأحزاننا، وأيقظنا من حلمنا الفلسطينيّ الفاتح نوافذَهُ على العالم الخارجيّ، وقال قوليْن:

أوّلهما: الفلسطينيّ بمجتمعه المنغلق نحو ذاته هو إنسان، تحكمه كلّ المنازلات والمآسي والمصائب والأفكار والهواجس التي يمكنها أن تحكم أيّ إنسان، على اختلاف جنسيّته وتاريخه وجغرافيّته.
وثانيهما: إنّ وهمَ البطولاتِ الفلسطينيّة لم يرفعنا إلى مصافّ الأنبياء، الأتقياء، الأولياء.
إنّ فضاءات البوح الصريح بما حلَّ بنا، وبما يمكن أن يكبّلَ حاضرنا، تلك الفضاءات لا يمكنها أن تتمّ إلّا بأمريْن تصرّح بهما الرواية وتعتمدهما:
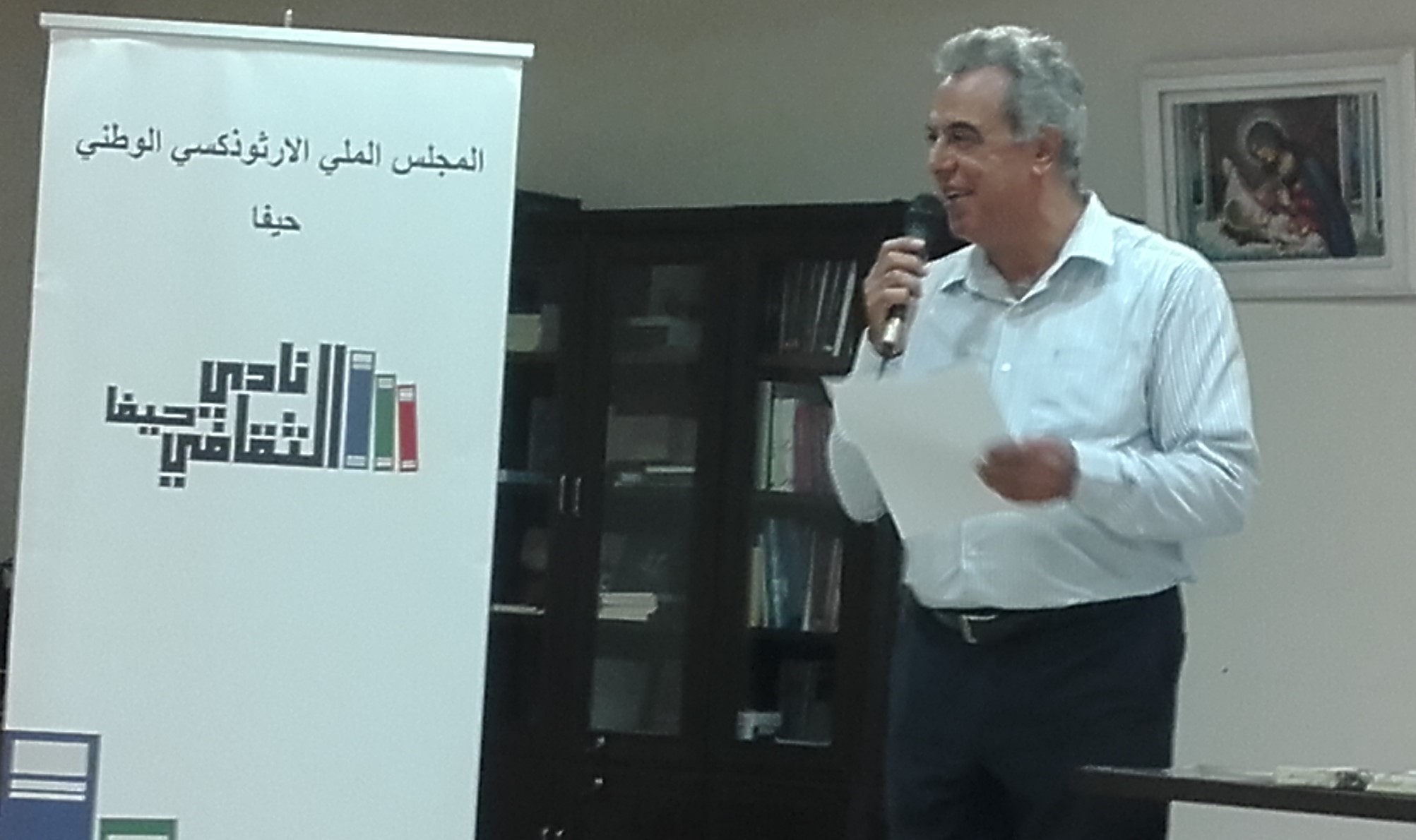
أوّلهما: أن نبتعد جغرافيًّا عن موقع الألم، عن القرية، عن بيروت، عن فلسطين، لنتمكّن من الهروب من القيود الاجتماعيّة التي من الصعب كسرُها، والتي تكبّل أوتارَنا الصوتيّة والعقليّة فنخشى البوح، لذا كان هروب شروق من بحر سوريا، وهروب إياد من وهم البطولات، وهروب حياة من المجتمع الفلسطينيّ الرافض للتصديق بأنسنة القائد الاجتماعيّ وغيرهِ.
ثانيهما: أن نستدعيَ الماضي “لنرى جروحنا ونلمسها، نلمسَ جروحَنا حتّى نُشفى منها، فلا شفاءَ لجرحٍ لا نلامسه بأيدينا” (الرواية ص. 55)
إنّ فضاءات البوح في الرواية









 موقع الوديان
موقع الوديان