
أ.د/ عبدالله بن أحمد الفَيفي
ألا يُدرِك أولئك المغتبطون بتلك النصوص التي يعزونها إلى الإمام (عَليِّ بن أبي طالب، كرَّم الله وجهه، ـ40هـ)، وهم يحسبون أنهم يحسنون صُنعًا واغتباطًا وإعلاءً من شأن الإمام، أنَّ في نِسبة الهُراء من هذا وذاك إلى (عَليٍّ) جنايةً على مقامه الكريم أيَّما جناية؟!
هكذا تساءل (ذو القُروح)، في ختام المساق السابق. قلتُ:
ـ على أنَّ (سحر سليمان عيسى)(1) تشير إلى أنه: «من الثابت أنَّ كتاب «نَهْج البلاغة»، جوهرًا وفِكرًا للإمام (عَليِّ بن أبي طالب، كرَّم الله وجهه)، في حين أنَّه تسميةً وتنسيقًا: الخُطَب والأوامر والكتب والرسائل والحِكم والمواعظ، فصولًا وأبوابًا للشَّريف الرَّضِي.»
ـ كيف صار ذلك «من الثابت»؟
ـ لم تذكر!
ـ ومَن ذا أثبتَه؟ وكيف؟ لو أنها قالت: «من الشائع»، لكان قولها صوابًا. ولقد نبَّه شُرَّاح «نَهْج البلاغة» من القدماء أنفسهم، وممَّن لا يُشكُّ في انتمائهم العَلَوي، إلى ما في عمل (الرَّضِيِّ، ـ406هـ) من خَلْطٍ وتخليط. فهذا (ابن أبي الحديد، ـ656هـ)(2)، مثلًا، يعلِّق على الخُطبة الرابعة في «النَّهْج» بقوله: «هذه الكلمات والأمثال ملتقطةٌ من خُطبةٍ طويلة، منسوبة إليه، عليه السلام، قد زاد فيها قومٌ أشياء حملتْهم عليها أهواؤهم، لا توافق ألفاظُها طريقته، عليه السلام، في الخُطَب، ولا تُناسب فصاحتُها فصاحته، ولا حاجة إلى ذِكرها، فهي شهيرة. ونحن نشرح هذه الألفاظ، لأنها كلامه، عليه السلام، لا يشكُّ في ذلك من له ذوقٌ ونقدٌ ومعرفةٌ بمذاهب الخُطَباء والفُصَحاء في خُطَبهم ورسائلهم، ولأنَّ الرواية لها كثيرة، ولأنَّ الرَّضِىَّ، رحمة الله تعالى عليه، قد التقطها ونسبَها إليه، عليه السلام، وصحَّحها، وحذف ما عداها». كما قال (ابن أبي الحديد)(3) عن الخُطبة الثانية في «النَّهْج»: «واعلم أنَّ هذه الكلمات… يَبْعُد عندي أن تكون مقولةً عُقيب انصرافه، عليه السلام، من (صِفِّين)، لأنَّه انصرفَ عنها وقتئذ مضطربَ الأمر، منتشرَ الحَبْل؛ بواقعة التحكيم، ومكيدة ابن العاص، وما تمَّ لمعاوية عليه من الاستظهار، وما شاهدَ في عسكره من الخذلان، وهذه الكلمات لا تُقال في مثل هذه الحال، وأخْلق بها أن تكون قيلت في ابتداء بَيْعته، قبل أن يخرج من (المدينة) إلى (البصرة). وأنَّ الرَّضِىَّ، رحمه الله تعالى، نقلَ ما وجدَ، وحكى ما سمعَ، والغَلَط من غيره، والوَهْم سابقٌ له، وما ذكرناه واضح.»
ـ وكأنَّه يقول: «كفَى بالمرء كذبًا أن يحدِّث بكلِّ ما سَمِع»!
ـ وهكذا يبدو القدماء أكثر عِلميَّة واحترامًا للمنهاج من المحدثين! ولقد حاول بعض المحدثين، من المنافحين عن (الشَّريف الرَّضِي)، باللُّتَـيَّا والَّتي، تسفيه كلام (ابن أبي الحديد) هذا، ذاهبين إلى أنَّ (عَليًّا) لا تنطبق عليه المقاييس البَشَريَّة أصلًا؛ فقالوا: «وهذا الاستنتاج من مثل هذا الشارح عجيب، فإنَّ ما ذكره، مسهِبًا فيه، إنَّما يجري بالنسبة إلى غير أمير المؤمنين، عليه السلام، ممَّن يقعقع له بالشِّنان، ويضطرب أمره من ماجريات الزمان، وأمَّا أمير المؤمنين، عليه السلام، فهو ليس كغيره، ممَّن يعتريه وهنٌ أو ضعفٌ أو فشلٌ أو ذُلٌّ، ولا ممَّن تزيده كثرة الناس أُنْسًا وقُوَّةً، وتفرُّقهم ضعفًا ووحشة، على أنَّ المطلوب من الرَّجُل العظيم- وإنْ كان دون أمير المؤمنين- أن يتجلَّد ويتظاهر بمظاهر الفُتُوَّة، وعدم المبالاة بالنوائب والحوادث.»(4)
ـ المسألة هنا ليست بمسألة «فُتُوَّة»، لكنها مسألة واقع، وسياسة، وصِدْق، وحِكْمة.
ـ بل إنَّ مثل هذه «الفُتُوَّة» المدَّعاة في مثل هذا الظرف ستبدو أشبه بالحماقة، أو بعدم المبالاة السلبيَّة، بالفعل. فأيُّ قائدٍ عظيمٍ، عَقِب معركة كمعركة صِفِّين، سيفرغ للسجع على المنابر؟! منوِّهًا بشهادةٍ تأتي «مُمْتَحَنًا إخلاصُها، مُعْتَقَدًا مُصاصُها…»!
ـ للهِ في خلقه شؤون! أمَّا تفضيل «نَهْج البلاغة» لدَى الغُلاة في (عَليٍّ) على ما سِواه من النصوص، بما في ذلك النصّ القرآني، فذلك ما لا أعلم قائلًا به قبل السيِّد (أحمد القبَّانجي).
ـ وهو قولٌ لا يقوم، لا على أثارةٍ من عِلم البلاغة، ولا على المفاضلة بين أساليب البيان، بمقدار ما يقوم على الميل العاطفيِّ، أو بالأحرى العصبيَّة الحزبيَّة، والانتصار المذهبيِّ.
ـ لكن الرجُل، رغم عمامته السوداء التي ما انحطَّت عن هامته، يصف نفسه بأنَّه ليبراليٌّ قُح، حداثي، وجداني، متمرِّد على كلِّ الأصول والثوابت والتراث!
ـ سلِّم لي على اللِّيبراليَّة العَرَبيَّة، مع حداثتها الاتِّباعيَّة! إنَّما هو المِراء الفارغ، أو حتى الجِدال الأيديولوجي المحض، للطعن في «القرآن»، يَمنةً ويَسرة، فما يخدم هذا الغرض، أهلًا به وسهلًا! ولو كان (القبَّانجي) كـ(الشَّريف الرَّضِي)، لاستحى من قوله، بَيْدَ أنَّ للجاهل من الجرأة ما ليس لغيره. قال (الشَّريف)(5): «وإنِّي لَأقول أبدًا: إنَّه لو كان كلامٌ يلحق بغباره [مشيرًا إلى «القرآن»]، أو يجري في مضماره- بعد كلام الرسول، صلى الله عليه وآله– لكان ذلك كلام أمير المؤمنين عَليِّ بن أبي طالب، عليه السلام؛ إذ كان منفردًا بطريق الفصاحة، لا تزاحمه عليها المناكب، ولا يلحق بعقوه فيها الكادح الجاهد، ومَن أراد أن يعلم برهان ما أشرنا إليه من ذلك، فليُنعِم النظر في كتابنا الذي ألَّفناه ووَسَمْناه ب»نَهْج البلاغة«… وكلامه (عليه السلام)- مع ما ذكرناه من عُلوِّ طبقته، وحُلْو طريفته، وانفراد طريقته- فإنَّه إذا حاولَ ليلحق غايةً من أداني غايات «القرآن»، وجدناه ناكِصًا متقاعِسًا، ومقهقِرًا راجِعًا، وواقِفًا بليدًا، وواقِعًا بعيدًا.» فها هو ذا يفضِّل بلاغة الرسول على بلاغة (عَليٍّ)، ثمَّ لا يقارن ببلاغة «القرآن» بلاغةً أبدًا؛ فما سِواه بالقياس إليه النكوص، والتقاعس، والتقهقر، والرجوع، والوقوف، والبلادة، والوقوع بعيدًا.
ـ وما قولك في مَن يُصِرُّ على التماس مصادر سابقة للنصوص التي أوردها الرَّضِيُّ في «النَّهْج»؟
ـ نحن نعلم أنَّ بعض ما وردَ في «النَّهْج» قد وردَ في مصادر سابقة، وقد ضربنا على ذلك الأمثلة، في المقالات السابقة، ووازنَّا، ولاحظنا الاختلافات بين تصرُّف (الشَّريف) في روايات «النَّهْج» وروايات (الطَّبَري)، على سبيل المثال.
ـ لكن كثيرًا ما يدلون عليك بشهادة (الجاحظ)، بأن خُطَب عَليٍّ كانت محفوظة.
ـ هكذا يظنُّون، أو قل: هكذا يفترون على (الجاحظ)! وذلك في روايةٍ معنعنةٍ عن (زكي مبارك)(6)، حيث قال: «وقد أراد المسيو ديمومبين (Demombynes) أن يَغُضَّ من قيمة ما نُسِب إلى عليِّ بن أبي طالب من خُطَب ورسائل؛ استنادًا إلى ما شاع منذ أزمان من أنَّ الشَّريف الرَّضِي هو واضع كتاب «نَهْج البلاغة». أمَّا نحن فنتحفَّظ في هذه المسألة كلَّ التحفُّظ؛ لأنَّ الجاحظ يحدِّثنا أنَّ خُطَب عَليٍّ وعُمَر وعُثمان كانت محفوظة في مجموعات. ومعنى هذا أن خُطَب عَليٍّ كانت معروفة قبل الشَّريف الرَّضِي.» ونقول لك- يا زكيًّا يا ابن مبارك– لقد كان (المسيو ديمومبين) أصدق منك ومن تحفُّظاتك كلِّها!
ـ كيف؟
ـ هل حقًّا قال (الجاحظ) «إن خُطَب عَليٍّ وعُمَر وعُثمان كانت محفوظة في مجموعات»؟ أم في هذا القول ضربٌ من التدليس على القارئ؟! مَن يقرأ هذا الكلام المبارك لـ(زكي مبارك) يخيَّل إليه أنَّ الجاحظ قد شَهِد بأنها كانت هناك مجموعات مصنَّفة مشهورة، وربما مجلَّدات بتلك الخُطَب، ولعلَّ الجاحظ قد اطَّلع عليها! فدونك ما قاله (الجاحظ)(7)، وَفق سياقه، بلا زيادة، ولا نقصان، ولا تلبيس: «أنا أُوصيكَ أنْ لا تدع التماسَ البيان والتبيين، إنْ ظننتَ أنَّ لكَ فيهما طبيعةً، وأنهما يناسبانك بعض المناسبة، ويشاكلانك في بعض المشاكلة، ولا تُهمِل طبيعتك فيستولي الإهمال على قوَّة القريحة، ويستبدَّ بها سوء العادة. وإنْ كنتَ ذا بيان، وأحسستَ من نفسك بالنُّفوذ في الخطابة والبلاغة، وبقوَّة المُنَّة يوم الحَفْل، فلا تُقصِّر في التماس أعلاها سُورة، وأرفعها في البيان منزلة. ولا يقطعنَّك تهييُّب الجُهَلاء وتخويف الجُبناء… وقد سمعتَ الله، تبارك وتعالى، ذكرَ داوود النبيَّ، صلوات الله عليه، فقال: «وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَيْدِ، إِنَّهُ أَوَّابٌ» إلى قوله: «وَفَصْلَ الخِطَابِ». فجمعَ له بالحِكمة البراعةَ في العقل، والرجاحة في الحلم، والاتِّساع في العِلم، والصواب في الحُكم، وجمعَ له بفَصْل الخِطاب تفصيلَ المُجمَل، وتخليصَ الملتبس، والبَصَر بالحَزِّ في موضع الحَزِّ، والحَسْم في موضع الحَسْم. وذكرَ رسولُ الله شُعيبًا النبيَّ، عليه السلام، فقال: «كان شعيبٌ خطيبَ الأنبياء»، وذلك عند بعض ما حكاه الله عنه في كتابه، وجلَّاه لأسماع عباده. فكيف تهاب منزلة الخُطَباء، وداوود، عليه السلام، سَلفُك، وشعيب إمامُك، مع ما تَلَوْنا عليك في صدر هذا الكتاب من القرآن الحكيم، والآي الكريم. وهذه خُطَب رسول الله مدوَّنةٌ محفوظة، ومُخلَّدةٌ مشهورة، وهذه خُطَب أبي بكر، وعُمَر، وعُثمان، وعَليٍّ رضي الله عنهم.» هذا نصُّ (الجاحظ)، جاحظٌ أمام عينيك! فهل قال: «إن خُطَب عَليٍّ وعُمَر وعُثمان كانت محفوظة في مجموعات»، كما زعم (زكي مبارك)؟!
ـ الحقيقة، أنه لم يقل «محفوظة في مجموعات». بل لم يصرِّح بأنها «مدوَّنة محفوظة» كخُطَب الرسول. ولكن هل صحيح أنَّ هذه الأخيرة «مدوَّنةٌ محفوظة، ومُخلَّدةٌ مشهورة»، كما قال؟
[نناقش هذا في المقال التالي].ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (2012)، قراءات من المكتبة العَرَبيَّة، (عمَّان: دار البداية)، 117.
(2) (1959)، شرح نَهْج البلاغة، تحقيق: محمَّد أبي الفضل إبراهيم، (القاهرة: دار إحياء الكتب العَرَبي)، 1: 208.
(3) م.ن، 1: 143.
(4) الخطيب، عبد الزهراء، (1985)، مصادر نَهْج البلاغة وأسانيده، (بيروت: دار الأضواء)، 1: 50.
(5) (1986)، حقائق التأويل في متشابه التنزيل، شرح: محمَّد الرضا آل كاشف الغطاء، (بيروت: دار الأضواء)، 5: 167- 168.
(6) (1957)، النثر الفنِّي في القرن الرابع، (مِصْر: مطبعة السعادة)، 1: 69.
(7) (1998)، البيان والتبيين، تحقيق وشرح: عبدالسلام محمَّد هارون، (القاهرة: مكتبة الخانجي)، 1: 200- 201.
أ.د/ عبدالله بن أحمد الفَيفي
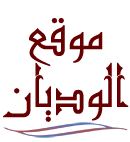 موقع الوديان
موقع الوديان