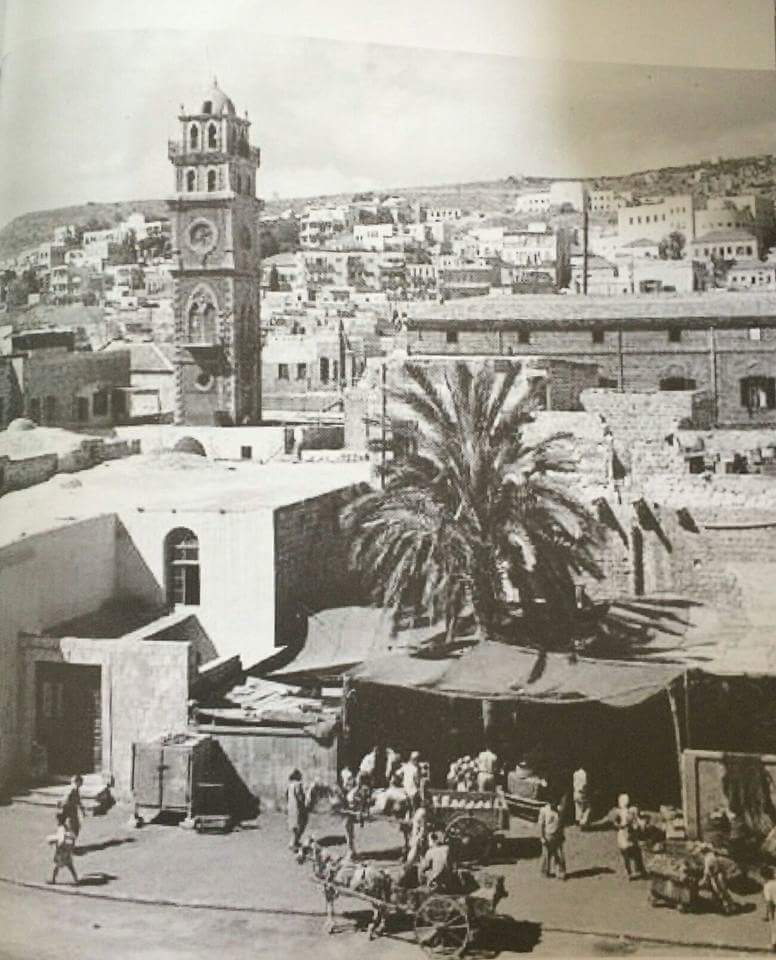
(الحلقة السَّابعة)
كان المدير الأب يواكيم قرداحي (جذوره بلدة القرداحة، سورية، ومسقط رأسه جزِّين، لبنان، خدم أهل حيفا وتوفَّى ودُفِنَ فيها عام الفٍ وتسعمائةٍ وأربعين)، يحمل عصاته صباحًا، “ويا ويل ويلو” الذي لا يُنشد أو لم يحفظ النَّشيد بعد، كان قاسٍ في تربيته، شديدًا ومحافظًا على النِّظام والتَّرتيب والطَّاعة وحسن الأخلاق..
وبعد وفاة الأب يواكيم قرداحي أدار المدرسة الأب كيريلوس خشيبون، من قانا الجليل، حتَّى سقوط حيفا، وشارك في سلك الإدارة، أيضًا، كلٌّ من الأب بولس منذر والأب أغابيوس الياس..
ومن بين المدرِّسين والأستاذة الذين يذكرُهم والدي هم: نعمة صباغ، استاذ اللغة العربيَّة، (وقد عرَّفه شاعرُ الأطبَّاء والخطيب والكاتب والطَّبيب قيصر خوري (6)، حسب ما جاء في كتابه “الذِّكريات ص 214″ على أنَّه أديبٌ وشاعرٌ، الشَّاعر المُجدِّد وعدوُّ الآنسات والسَّيِّدات رقم واحد!”)، وشريف حبيشي استاذ قواعد الشِّعر وبحوره، الياس حمام، استاذ اللغة الفرنسيَّة، حنَّا عمُّوري، استاذ الرِّياضيَّات، جبران حدَّاد، استاذ اللغة الإنجليزيَّة، الأب منذر بولس، وقد كان معلِّم الخطِّ من إحدى قرى المثلَّث لا يذكر والدي اسمه وكذلك الأستاذ نديم عبد النُّور، والاستاذ لطف أكلينضوس الحاج، استاذ اللغة الفرنسيَّة والإنجليزيَّة والطِّباعة على الآلة الكاتبة، وفيها مضى ثلاثة اشهر في التَّدريس وانتقل بعدها إلى مدارس القدس (حيث أنَّ والده الخوري أكليمنضوس الحاج مدفون في داخل باحة كاتدرائيَّة السَّيِّدة، في حيفا، إلى جانب ضريح المطران حجَّار، والتي كانت تُسمَّى، أيضًا، كنيسة الأم أو كنيسة البلد) ويذكر والدي أنَّ الأستاذ حمام كان يقول لهم أنَّه حين كان يسوع المسيح في مذوده في مغارة بيت لحم، خيَّروه إيَّ علم من بين أعلام العالم قاطبةً، أحلى، فكان المولود في مذوده يُشير بعينيه إلى العَلَم الفرنسيِّ، وعندما كان يُخطئ أحد التَّلاميذ في لفظ كلمة أو تهجئة حرف، خلال درس اللغة الفرنسيَّة، كان يكيلُ له الإهانات، بعد أن يطير ضبان عقله من محلِّه، قائلاً، هكذا يلفظون الكلمة، ويُصحِّح التلميذَ، زامًّا شفتيه، متابعًا بهدلته “معلوم طربوش ابوك معلَّق على أبراج لندن!”، حيث كانت المدرسة تحت إشراف ورعايَّة حكوميَّة فرنسيَّة لفترة طويلة من الزَّمن، كما هو معروف..
وكان المعلِّمون يُشجِّعون التَّلاميذ في أوقات الفراغ، من استراحات الدَّوام، على التَّحدُّث مع بعضهم البعض، باللغات الأجنبيَّة، لكي يتمكَّنوا منها، ويتحدَّثونها بطلاقة، وإذا وجِدَ طالب يتحدَّث اللغة العربيَّة في فرصة الدَّوام، يكون عقابه نسخ عدة صفحات من كتاب اللغة، التي كان من المفروض أن يتحدَّث بها..
لم يكن لطلاب المدرسة لباسًا موحَّدًا، الأمر الذي كان ملفتًا للنَّظر، حيث كنتَ تستطيع أن تُميِّز بين الطلاب، من هو ابن الغنيِّ ومن هو ابن الفقير، وكانت ملابسهم تدلُّ النَّاظر على من هم التلاميذ الفقراء والمحرومون ومن هم الأغنياء والميسورون، وكان لدى رجال الدِّين والمعلمين لفتة خاصَّة لأبناء الأغنياء، بأنَّ هؤلاء هم أبناء الذَّوات، لذلك كانت لغالبيَّة ابناء الفقراء نقمة على الأغنياء وأحباب الأغنياء والمتعاطفين معهم “هذا ابن عائلة”..!
وكان في مدرسة واحدة وفي صفٍّ واحد طلاب من مختلف الأديان، حيث كانوا يشعرون بالإنتماء للوطن، فلسطين، وإلى لغة واحدة هي العربيَّة، فقد كان اليهود ابناء فلسطين أو أبناء المشرق العربيِّ السَّاكنين في فلسطين يتكلَّمون العربيَّة، “يهود اولاد عرب” أو العربيُّ اليهوديُّ أو عربيٌ دينه اليهوديَّة، يهوديٌّ ابن عرب، وإذا سكنوا بلادنا بعد أن تركوا بلادهم لم يشعروا أنَّهم عادوا إلى أرض الميعاد، بل شعروا أنَّهم انتقلوا من هذا الإقليم إلى ذاك الإقليم، بحكم الوحدة الجغرافيَّة العربيَّة غير المتجزِّئة، الوطن العربيُّ الواحد، ويكتب في هذا د. سليم تماري في كتابه “الجبل ضدَّ البحر” (ص 225): يتحدَّث كمال صليبي في سيرته “طائر على سنديانة” خلال سنوات دراسته في بيروت الإنتدابيَّة عن نوعين من الطُّلاب اليهود الذين عاشوا حينذاك. المجموعة الأولى كانت من اليهود السُّوريِّين والعراقيِّين والعديد منهم نشطوا في تلك الفترة في حلقات وطنيَّة معادية للإستعمار في سنوات الثَّلاثينات والأربعينات، امَّا المجموعة الثَّانية فكانت مكوَّنة من الطُّلاب اليهود الآتين من فلسطين والنَّاطقين بالإيديش ومعظمهم ذوو توجُّهات سياسيَّة صهيونيَّة. ويُلاحظ الكاتب أنَّ المجموعة الأولى كانت منسجمة فكريًّا وثقافيًّا في الحلقات الطُّلابيَّة العربيَّة (ومعظمهم من أبناء الطَّبقات الوسطى العلمانيَّة)، بينما تميَّزت المجموعة الثَّانية بالإنعزال عن رفاقهم. فهم نادرًا ما تكلَّموا العربيَّة..وكانوا يتوجَّهون إلى محيطهم بأعين حذرة ومُتشكِّكة”.
وكنتَ ترى أنَّ “اليهوديَّ ابن العرب” كان حاضرًا في الحركات المناوئة لظلم العثمانيِّين،
واستمرَّت في التَّميُّز في هذا الإطار حتَّى بعد ظهور الحركة الصَّهيونيَّة في فلسطين، لكنَّ سرعان ما بدأ هذا التَّميُّز بالإنحياز تجاه الحركة الصَّهيونيَّة التي تآمرت مع الإستعماريْن البريطانيِّ والفرنسيِّ والرَّجعيَّة العربيَّة، على مشرقنا العربيِّ في مشروع الوطن القوميِّ لليهود، حيث يكون من خلال ذلك قطع تواصل الوطن العربيِّ، القوميِّ والجغرافيِّ والوجوديِّ، وهذا يوجِّه ضربة تقصم ظهر العرب وتضربه في صميم مشروعه الوحدويِّ وتشلُّ بذلك طموحات الحركة الوطنيَّة التَّحرُّريَّة العربيَّة، بفرضيَّة، وهي الصَّحيحة أنَّه إذا انتصرت الوحدة العربيَّة الوطنيَّة، بتركيبة “عصبة التَّحرُّر الوطنيِّ في فلسطين” على اساس قوميٍّ ووطنيٍّ وطبقيٍّ، سيكون الحلُّ لمسألة الأقليَّة اليهوديَّة في فلسطين سليمًا، وتكون “العُصبة” قد نزعت فتيل الصَّهيونيَّة، بزوال خطرها، وتحجيمها وتقليم أظافرها.
فقد دعت العُصبة والحزب الشُّيوعيُّ الفلسطينيُّ في اواخر الثَّلاثينات من القرن الماضي إلى اقامة جبهة شعبيَّة متَّحدة معادية للاستعمار البريطانيِّ وللصَّهيونيَّة..
تحدِّث والدة الكاتب محمد الأسعد عن اليهود فتقول: “أمَّا يهود بلادنا فكانوا يتحسَّرون ويقولون: إنَّنا نريدكم أن تبقوا، فنحن لا نحبُّ هؤلاء الغرباء” (” أطفال الندى” ص 40) وتُتابع: “فليتبنَّ الشَّيطانُ هذه الأسماء العجيبة “هرتسوغ” و”بيغن” و”بردوفسكي” و”لوين”.. فحتَّى التَّوراة لا تعرف هذه الأسماء..ولم يمرّ أصحابها في ذاكرة صخرة أو طريق من طرق بلادنا” (” أطفال الندى” ص55).
ويذكر والدي بعضًا من زملائه في الصَّفِّ وهم: ماير صدقا أو صدقة (وأشقَّاؤه الثَّلاثة من يهود لبنان في صفوف مختلفة في المدرسة)، فهد منقَّش من البصَّة وأخوه في صفٍّ أدنى، فؤاد شمَّا، وديع الشِّيني، صبحي خضر، طناس زهر، وليم عصفور وأخوه عبد المسيح في صفٍّ أعلى، سهيل حنَّا دكلوش، جورج حدَّاد، فؤاد صنبر وابن عمِّه شوقي صنبر، أحمد عبد الواحد السَّيِّد، من مصر، حيث كان والده يعمل في ميناء حيفا، يوسف صبَّاغ، سليم شامي (وأشقَّاؤه في صفوف مختلفة في المدرسة)، سعيد عبيد، صبحي جدع، بنيامين لوسيَّا، إدوار غريب، إدوار نصر، بشارة المر، الياس منصور وشقيقه، جبرا وشقيقه منيب نحَّاس، الياس لطيف، صبحي عفارة (وأشقاؤه إميل ونيقولا في صفوف مختلفة من صفوف المدرسة)، ميشيل وانطوان دانيال، فؤاد الأبيض، إدوار نعمة وشقيقه فؤاد نعمة في صفٍّ أعلى، زكي شمَّا، جميل (في صفٍّ أعلى) وغابي واسكندر شومر واسكندر جودي، أما موسى مليوار ونايف عبد النُّور وإيليا صنبر وداود تركي (شقيق والدي) فكانوا في صفوف أعلى، وشقيق والدي بطرس، الأصغر، كان في صفٍّ أدنى وكان زميله في الصَّفِّ حنَّا نعمة الكشك..
كان حنَّا نعمة الكشك زميل بطرس في الصَّفِّ، وهو ابن عمِّه من الدَّرجة الثَّالثة، حيث كان أجدادهما من جدٍّ واحد، يتبعون للجدِّ الأوَّل داود، الذي اتى من غوطة الشَّام برفقة والدته، وسكنا في قرية مغار حزُّور، قبل قرنين من الزَّمن أو يزيد، في منطقة تماس الحارتين المسيحيَّة والمعروفيَّة، أمَّا اسم الكِشك فله قصَّته!
وكما هو معروف، للجميع، أنَّ الكشك هو عبارة عن خليط من البرغل أو القمح المجروش الخشن والمخْتَمر في اللبن الرَّائب والحليب والملح حيث يُنشَّف لاحقًا على قطعة قماش بيضاء ناعمة، ويبقى الكشك جافًّا وحاضرًا لساعة طهيه، حيث يتمُّ تحضيره مع أطباق اللحم والأرز، والمناسف..
يقول والدي إنَّ جدَّ عائلة الكشك، عمَّه، قد وقع في غرام بنت من القرية، وكان العشق والغرام متبادلاً وبرضاهما وقناعتهما، لكنَّ أهل المحبوبة رفضوا هذا التَّقارب، جاهدين منع هذا القِران، وحاولوا منع زواجهما، بكلِّ الوسائل، دون جدوى، “القلب وما يريد والعين وما تشوف” ولو تزوَّجا لأقاموا الدُّنيا ولم يُقعِدوها إلى يومنا هذا، ولبقيت العداوة بين العائلتين إلى يوم الدِّين، فاتَّفق الحبيبان على الهروب من القرية، على أن يتمَّ لقاؤهما سرًّا في أطراف البلدة، أراد أن يخطفها خطيفةً، يركبان صهوة فرسه ويهربان، لا يعرفُ سرَّ التَّوقيت وسرَّ المكان إلا مالك المُلك، “قبل فجَّة الحَمار”، هو يخرج بعد خروج المزارعين والحرَّاثين ودوابهم إلى كرومهم وحقولهم أو عند خروج عجَّال البلدة ودوابه إلى المراعي، وهي تضع حاجيَّاتها في كيس من الخيش في مكان ما، قرب سياج بيتها، دون أن يعلم بالأمر أحدٌ، على أن يأتي فارس أحلامها وعشيقها الموعود والمرفوض لأخذ أغراضها وينتظرها عند مدخل القرية الشَّمالي، وهي تترك بيتها زمن “معالاة” الطَّبيخ، حين تنشغل النِّسوة في الطَّهي، حتَّى يُشمِّلا إلى الشَّمال إلى بلاد الله الواسعة والرَّحيبة من ارض بلاد الشَّام الحبيبة والعزيزة، لكنَّه انتظرها طويلاً “متل اللي قاعد بستنَّا بعقلاتو”، وحين تأخَّرت، “لعب الفار في عبِّه”، وشكَّ في مكيدة لهما وخاف عليها من مكروه يجوز أنَّه قد أصابها، فسطوة والدها قاهرة وعاتية، ذلك الوالد “الشَّرَّاني” الذي يتأبَّط شرَّ النَّاس، فكيف لا يتأبَّط شرَّ من يودُّ التَّقارب من ابنته، دون رضاه وإرادته، صراع ما بين سطوة العشق وسطوة البطش، ما بين القوَّة والضَّعف، ما بين الحسِّ والجهل، وما بين هاتين السطوتين فرق كبير، ففحص كيس الخيش الذي كان بحوزته فوجده مليئًا بكدرات الكشك، فاحتقنت عروقه دمًا وغضبًا وعنفوانًا وحقدًا، أراد أن يعرف ماذا حلَّ بها، وهل أصابها مكروهٌ، ذُبِحت أو قُتِلت أو هُجِّرت أو اقتنعت بمراد والده “ودعست على قلبها وعلى مشاعرها”، ويجوز أن ضَبَعَتها ضباعُ الأحراش، في نفخة طويلة من فمها في وجه العاشقة، حيث أنَّ منظر الضِّباع بشع جدًّا ورائحتها كريهة، لكونها تتغذى على الجثث المُتحلِّلة، الفطائس، وإذا اردْتَ أن تذمَّ شخصًا نتيجة رائحته الكريهة، أو لرائحة فمه الكريهة، البَخَر، تقول “ريحتو بتقوِّس الضبع”، حتَّى أنَّها تُسيطر على من يشمُّها و”تضبعُه” ويصبح تحت سيطرتها، فهل “انضبعت” حبيبته، وتاهت معهم، أم انَّ الضِّباع سحَبَتها غيلةً إلى وكرها، والإحتمالان هما، إن لم يصطدم رأسها بقوس المغارة، فإنَّها لن تصحُو من ضبعتها فتفترستها الضِّباع في جوف أوكارها، وإن ارتطم رأسها بقوس مدخل المغارة، وسال دمها من جبينها، ستصحو من انضباعها وتعرف ما جرى لها، فتعود أدراجها إلى بيتها، بسرعة، يقينًا منها أنَّها في خطر، أو أنَّ الضَّبع راقب حركاتها من بعيد فدخل وكره، وحين اقتربت من مسكنه بدأ يُصدِرُ أصواتًا وعويلاً مخيفًا، مناجيًا المساعدة، تشبه أصوات الإنسان وضحكاته وبكائه ومناجاته، فدخلت موكرته وبدأت هي تُفتِّش عن طالب المساعدة، وكانت مفاجأتها، وإذ به ضبع يترصَّد فريسته بأصاوته، فضبعها في بيته وافترسها دون مُخبِّر أو (وهذا احتمال ضعيف) حين دخلت عليه جرَحَها بانيابه بعد أن حاول افتراسها، فاستيقظت من انضباعها، وطلبت منه أن يتركها بعد أن وعدته بما هو أشهى من لحمها، فتركها وانتظرها طويلاً، فسَلِمت منه، روحًا وجسدًا وبات ليلته يتضوَّر جوعًا باحِثًا عن فريسة أخرى..
والله أعلم ﴿..بذاتِ الصُّدور..﴾..
ويُحكى أنَّ ضبعًا في البريَّة تعرَّض لعمليَّة قنصٍ فاشلة من مجموعة صيَّادين، فهرب الضَّبع منهم ولجأ إلى أعرابيٍّ كان مرتاحًا في خيمته، وحال دخوله الخيمة اعتبره الأعرابيُّ مستجيرًا به وطنيبًا عليه، وعليه حمايته ومساعدته والدِّفاع عنه أمام هؤلاء المعتدين، دون أن يسأله عن اسمه وحسبه ونسبه وغايته وسبب هروبه وعن مدَّة إقامته، عليه حمايته قبل كلِّ شيئ، حتى لو كلَّفه ذلك قطع رأسه، إن كان انسانًا، لكنَّ الأعرابيَّ تعامل معه وكأنَّه إنسان، أمَّا المهاجمون فقد غادروا المكان امام وقفة الإعرابيِّ الدِّفاعيَّة، بعد ان اعلمهم انه في حمايته، فتركوا الضَّبع وشأنه، عند الأعرابيِّ، الذي قدَّم له المأكل والمشرب والمأوى وحسن الوفادة، وحين خلد الأعرابيُّ إلى النَّوم بعد أن أكرم وِفادة الضَّبع، قام الضَّبع من فراشه الجديد الدَّافئ بالانقضاض على الأعرابيِّ وبقرَ بطنه وافترسه. وحين أتاه اقاربه وابناء قومه صباحًا وجدوه صريعًا “يسبحُ بدمه” فاغرًا فاه، فتبيَّنت لهم الحقيقة، وقال شاعرهم في هذه الحادثة:
ومَنْ يَصنَعُ المَعروفَ مَع غَيرِ أهلِهِ يُلاقي كَما لاقى مُجيرُ أُمِّ عامِرِ
أعَدَّ لَها لمَّا استجارَتْ بِبَيتِهِ أحاليبَ البانِ اللقاحِ الدوائرِ
وأسمَنَها حتَّى إذا ما تَمَكَّنَتْ فَرَتْهُ بانيابٍ لَها واظافِرِ
فَقُلْ لِذَوي المَعروفِ هذا جَزاءُ مَنْ يَجودُ بِمَعروفٍ على غَيرِ شاكِرِ
ويكتب استاذي ومعلِّمي الشَّاعر حنَّا أبو حنَّا في مسلسله الرِّوائيِّ الأسبوعيِّ في صحيفة “المدينة” الأسبوعيَّة والصَّادرة في مدينة حيفا، “فستقيَّات”، قصَّة تتناولها الأجيال المتعاقبة، حيث كنت قد سمعتُها من والدي، عن الضَّبع والإنضباع ووكر الضَّبع وارتطام الرأس بمدخل المغارة فيصحو..
“حين التقى صيَّاح بالضَّبع، لم يقوَ على ضربه، بعصاه التي في يده، خوفًا من الضَّبع، لأنَّ الخوف قطَّاع العصب، يشلُّ، فبعد أن نفخ الضَّبع في وجهه رماه أرضًا وطُرِحت حطَّته وعقاله أرضًا، ودخل في غيبوبة، وقام بعدها يركض وراء الضَّبع، ويناديه:”هي يابا يابا..هي يابا” ويُتابع “هي يابا استنَّاني”، “اقترب صيَّاح من باب المغارة، دخل الضَّبع يُحضِّر للوليمة، اندفع الرَّجل يركضُ بذعرٍ، ليلحق “أباه”، وفجأةً ارتطم رأسه بالصَّخر عند أعلى فتحة المغارة. فُشِخت رأسه وسال منها الدَّمُ على وجهه..فصحا صيَّاح. نزيف دمه أعاد إليه وعيَه وانحلَّ انضباعه، وأدرك الخطر المحيط به فركضَ
هاربًا..فنجا”.
فالجرح النَّازف يوقظُ صاحبه إن كان حيًّا، وإن كان صاحبُه ميِّتًا فإنَّه سيبقى ميِّتًا دون يقظةٍ “من يهُن يسهلُ الهوانُ عليه وما لجرحٍ بميِّتٍ إيلام” ويبقى “العِلم عند ربِّ العِلم.”
وعاد العاشق المُتيَّم إلى دياره مكسور الخاطر، حرِدًا، مكروبًا، يحوم جوار دارها علَّه يلحظها بأنَّها بخير ولم يصبها مكروهٌ، لكنَّ السِّرَّ في اختفائها بقي مفتوحًا، فهناك من قال إنَّها خرجت إلى دار عمِّها في حوران وتزوَّجت من أحد أبنائه، وهناك من قال أنَّها اعتكفت عند اقاربها في لبنان، ولزمت دور العبادة هروبًا من العشق، ووجدت فيه ملاذًا يحرِّرها من إكراه أبيها، وتكون بذلك قد جلدت ذاتها وذات محبوبها وعاقبت نفسها ونفس عشيقها، فلو هربت معه، لكانت قد تحرَّرت من جميع هذه القيود وعاشا في ثبات ونبات وخلَّفا صبيان وبنات، لكن السُّؤال يبقى مفتوحًا، هل غدرته في حبِّها، أم أنها كانت رهينة ظلم والدها..
أمَّا ماذا حصل للعاشِقَيْن بعد ذلك فاسألوا صاحب الشَّأن..
..(نتواصل، انتظروا وشكرًا)
 موقع الوديان
موقع الوديان