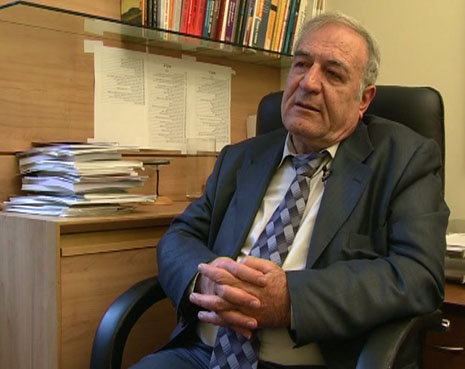يوم قرّر أيمن أن يترك بلده الخليل، ليس لكره لها، فهو يحبّها حبّا جمّا، يحبّ عنبَها ويحبّ فيها أكثر كلّ ما تفتّق عنه ذهنُ أبناءِ فلسطينَ من نكات “دبّوها” في ظهور أهلها، وأحيانا ظُلما ودون أن يكون لأهلها فيها “لا ناقة ولا جمل”، يحبّها ويرويها باللهجة الخليليّة الخاصّة ودون تحفّظ، جاعلا من نفسه ومن أهله موضعَ ضحِكٍ في ظرف هو ومن معه من النزلاء أشدُّ من هم بحاجة للضَّحِك، ولا بأس من إضافة بعض “البهارات”.
يوم قرّر ذلك، قرّره جريا وراء الرّزق الذي ضاقت أبوابُه احتلالا جثم وثقل كلكلُه، هذه على الأقل روايتُه، أمّا بعضُ العارفين في الأمور من أصحابه يقولون: أنّه تركها جريا على مقولة مشهورة حُوّرت خدمة للهدف: “ما أجبرك على هجر حبّ إلا الأحبّ”. فأيمن أحبّ فتاة مقدسيّة قبضت على تلابيب قلبه بقوة، فسحبته من شحمة أُذن قلبه وراءها إلى القدس.
المحبّ محبّ في كل زمان ومكان، فمثلما أحبّ طفولتَه وفتوّته في الخليل أحبّ فترة شبابه المبكّر، أو في لغة علماء الاجتماع في تقسيم سنيّ العمر فترةَ رشده، في القدس، وأحبّ حبَّه فيها، لا بل أحبّ أكثر أمَّ الكل، أمّه وامّ مقدسيّته وامّ الخليل وامّ القدس، الوطن، هكذا سليقيّا دون توجيه أحد، اللهم حليبِ أمّه، ولا كي يرضي قائدًا.
كانت أيامه في القدس العتيقة غنيّة بالحبّ، أحبّ حجارتها وأحبّ أزقتها وأحبّ أهلها، وأكثر ما أحبّ، بقايا حارة “شرف” التي سكنها أو على الأصح أسكنته فيها “مقدسيّتُه” قريبا من باب السلسلة.
وعندما تسألُه لماذا هذا الحبُّ الخاص، يجيبُك: “أن هذا الحيّ منطقةٌ سكنية قديمة في القدس، ملاصقة لحارة المغاربة، كانت تملكها عائلة عربية تدعى عائلة شرف، وفي أثناء الانتداب البريطاني، استأجر اليهود معظم الحارة وتملكوا جزءا منها. وقد هُدمت هذه الحارة خلال حرب النكبة بين العرب واليهود، وخرج منها جميع السكان اليهود وبقيت على حالها خلال العهد الأردني، وبعد احتلال القدس الشرقيّة ادّعى اليهود ملكيّة هذه الحارة، وطردوا آلاف سكانها الفلسطينيين، ودمروا معظم منازلها، وحولوا اسمها إلى “حارة اليهود”.
ويتابع، وعلى ذمّته طبعا: “أن ما تبقّى منها في الطرف الجنوبي الغربيّ للحيّ الإسلامي، وصار جزءا منه، يجب أن يبقى خطّ الدفاع أمام تمدّد حارة اليهود التي قامت على أنقاض حي المغاربة الذي كانت هدمته إسرائيل.”
وبغضّ النظر، فالرّزقُ في القدس فتح لأيمنَ الأبواب على مصاريعها، فلم تكن دكّانُه الصغيرة تخلو من محبّي عنب الخليل صيفا، والدّبس والزبيب وقمر الدين شتاء، أضاف عليها من كلّ ما كانت تدرّه أرضُ الخليل الخصبة من الفواكه والخضار، والبقول أخضرَ ويابس. لم يعكّر عليه صفو أيامِه إلا الأقاويلُ التي انتشرت عن دخول رِجْلٍ غريبة الحيّ بعد أن خلّت لها المطرحَ أخرى تغرّبت عنوة، وما لبثت الأقاويل أن صارت حقيقة، لا بل أكثرَ من ذلك صار يستصبح فيها خارجة ويتمسّى فيها عائدة.
مرّت أيام صعبة على أيمن كان أبطالها مقدسيّته وثمرُ بطنها التوأمين، وخرقُ خطّ الدّفاع، لم يكن من الصّعب على الزبائن أن يلحظوا أن أيمن الضاحكَ المُضحك، إلا على ما ندر، صارت أحواله “غير شكل”، راح يغيب عن الدّكان كثيرا والولد المساعد لا يعرف جوابا إلا: “راح يجيب بضاعة” ويجيء الغد ولا بضاعةَ جديدةٌ ولا يحزنون، والسهوُ صار صاحبَه الذي لا يبرحُه إلا لماما، وراحت كلّ محاولاتهم سبر غوره هباء يذروها بعودة سريعة إلى طبيعته الضاحكة المُضحِكة.
كانت ليلةٌ ظلماءَ مزّق صمتَها أزيز رصاص، وما فتأ أن هتكت ظلمتَها أنوارُ قنابلَ ضوئيّةٍ شكّلت ظلالا متحرّكة للمآذن والقُبب عبر الأزقّة والحواري، التي امتلأت ضجيجا هجينا تتخالط فيه أصوات الجنود وقرقعة نعالهم وعواءُ لا سلكيّاتهم. وتلألأت بعض أنوار من شبابيكَ قديمة، أطلّت عبرها بعضُ الرؤوس حذرةً، أجفلتها أصوات مكبّرات صوت تعلن منع تجولّ حتّى إشعار آخر، وطال أمد الإشعار وانتهى المنع كما بدأ عاقرا.
حينما كان يحكي أيمن حكايته مع الحيّ وتلك الليلة، إذا طُلب منه ذلك، فما كان من شيمِه التباهي، كان ينهيها وليس قبل أن يتنهد عميقا وبما معناه: “أكثر ما آلمني ويؤلمني ليس الزنازين ولا الشّبحُ ولا حتّى الحكم، ولا البعدُ عن العائلة، ولكن أني لا زلت لا أعرف حتّى اليوم كيف وصلوني، ولا أعرف إن كنت سأعرف يوما”.
المهّم أن أيمن ومنذ دخل القسم أضفى عليه وعلى نزلائه الكثير من روحه الخليليّة المرِحة، ولكنه أحضر معه تجديدا آخر أهم، فما توجه لزميل إلا ب- “يا مواطن”، لا يا أخ ولا يا رفيق ولا زميل ولا يا مناضل ولا…، وما لبث أن ضاع اسمُه من على لسان النزلاء، فصار الكلّ يناديه ب-“المواطن”، ولا شكّ أن الكثير من الجُدد لا يعرفون اسمَه الأصلي.
المواطن لم يكن قد أنهى الثانويّة في حياته، فصار في الأسر قارئا نهما ومجادلا مرّا في الكثير من الأمور، وصار يكتب الخاطرة والشعر المسجوع والقصّة القصيرة والطويلة، إلا إن معضلتَه ظلّت قواعدُ اللغة، فلا المرفوع كان معه بخير ولا أخوته من المنصوبات والمجرورات، وكلها كوم وكتابة الهمزة كوم.
يوم جلس في “الفورة” إلى أحد النزلاء الجدد العارفين في اللغة قدرا، والذي يروي أيمن أنه استثمر وجوده معوانا له على اللغة، وضاحكا مستغفرا، حين يروي حكايته مع “الاستاذ” كيف فاجأه هذا وبعد لأي مع أحرف الجرّ ومجروراتها، في قصّة راح يقرأها له، قائلا: “ولك يا رجل… هاي بتجر الله !”
لم يستوعب أيمن سريعا ما قصد الاستاذ، فأجابه ولكن ضاحكا ملء فيه وهو المتديّن الذي لا تفوته صلاةٌ: “شووو…استغفر الله يا زلمة …!”
وحين أفهمه المقصود ضاربا له الأمثال، زاد ضحِكُه وأجاب: “والله ما عدت أنساها وأغلط فيها حتى أموت… !”
كانت أحداث القصّة تدور حول مخيّم طلائع صيفيّ احتفاء بإنهاء سنتهم الدراسيّة، على أحد جبال الخليل الوعرة العالية، وحتّى هذا استكثره عليهم المحتل فهاجم جنوده أكثر من مرّة المخيّم يعيثون فيه فسادا بشتّى الحجج، وقد أدّى الأمر لمواجهات واعتقالات، غير أن الفِتْيةَ انتصروا وحافظوا عل المخيّم، هذا الانتصار لم يرُق لإحدى السيّارات العسكريّة “الوعريّة” المنهزمة وظلّت تجوب الأنحاء وجعيرها يملأ الفضاءات، تدوس على جراح الجبل الحديثةِ وقعِ النصل، جيئة وذهابا استفزازا.
جبال الخليل تحبّ أهلها أكثرَ ممّا يحبّونها، زوّدتهم بالدفء شتاء والنسيمِ العليل صيفا، وزوّدت عيونَهم بالماء الزلال، ومن طيّاتها أطعمتهم، واحتضنت ثائريهم حين كانوا بحاجة لدفء حضن في استراحة محارب، وإن قُطّعت أوصالُها مؤخّرا، جراحا بالطول والعرض لم تُعطَ فرصةً للاندمال، ظلّت طيّبةَ المأوى.
لم يعد يحتمل أحدُ الجروح الما زالت دامية المحيطةِ بالمخيّم، الألمَ فانتفض تحت عجلات السيّارة جاعلا “عاليها واطيها”، وخالطت أنّات الجند العالية وصراخُهم حجارةَ وشجيراتِ قنْدول وسُوّيد وبلّان وسنديان وملّ وبُطُم وزعتر وجعساسَ الوادي بعد أن دعكها الانقلاب المدوّي، وقد ودّت هذه مع انكسار بعض غصونها روائحها الطيّبة مخلوطة بآهات ألم عالية، ودّتها صعودا نحو المخيّم.
الهَرجُ والمَرج بين حرّاس المخيّم ومن بقي ساهرا حول عيدان موقد كانت بدأت تنفض أنفاسها الأخيرة، كان سيّدَ الموقف، انقسم الحرّاس والساهرون على أنفسهم، واحتدّ النقاش موقظا النُوّم، وحُسم النقاش بالغالبيّة.
حين طوّقت قوّة مدجّجة المخيّم وترجّل رجالها شاكي السلاح متأهّبين لجولة قمع أخرى بعد انقطاع الاتصال بدوريّتهم، كان الفتية يضمدّون جراح الجنود حول نار الموقد التي علا لهيبها بعد أن أيقظوها من غفوتها.
وحين كان المواطن يتقدّم مع الأحداث قارئا، ضاع “الاستاذ” مع المفارقة المشرئبّة من بين حروف الأحداث، بين الضمّة والفتحة والكسرة تاركا إياها تسرح على هواها دون تدخّل، حتّى تلك منها التي تجرّ “الله” وكان أيمن أقسم ألا يخطئ فيها مدى الحياة.
سعيد نفّاع
أوائل تشرين الثاني 2017
 موقع الوديان
موقع الوديان